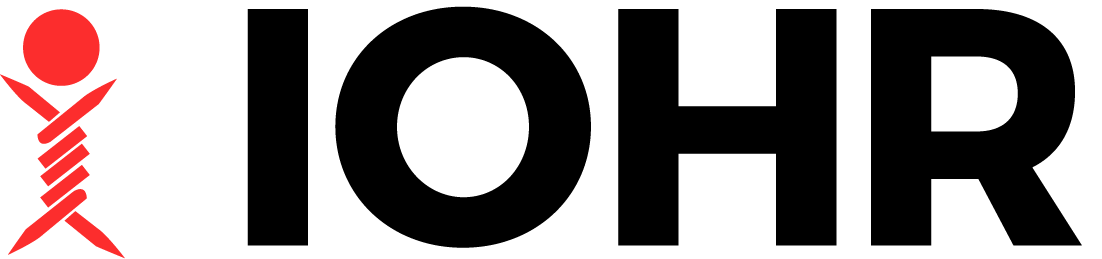عقيل عباس
حرية التعبير هي جوهر الديموقراطية وروحها. من دونها لا يمكن الحديث عن النظام الديموقراطي. بعكس الشائع، حرية التعبير تتجاوز حق الناس في قول أفكارهم ومعتقداتهم، لتشمل سلوكهم وخياراتهم في الحيّز العام وكل ما يتعلق بالتعبير عن ذواتهم، بدءاً من ارتدائهم الملابس، مروراً بتبنّيهم الإيمانات الدينية والفكرية، وانتهاءً بفعل الانتخابات كتعبير عن رأيهم السياسي. تعني حرية التعبير، باختصار، أن يعيش المرء ذاته في الحيّز العام ما دام هذا العيش لا يسبب ضرراً ملموساً للآخرين.
بدايات حرية التعبير قديمة، تعود إلى مصادر مختلفة ومتباعدة زمنياً وجغرافياً: رافدينية وإغريقية ويهودية ومسيحية وإسلامية. تلاقت هذه البدايات حول فكرة عامة تبناها الأقدمون تتعلق بقدرة الإنسان على التفكير وتأمل نفسه وإعلان ما يفكر به، لكن لم تكبر هذه البدايات وتنتظم في بنية مؤسساتية محمية بقوانين وثقافة عامة. بدأ هذا يحدث تدريجياً مع بروز الحداثة الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في إطار كبح الصراعات الدينية، عندما اتخذ التعبير عن الذات أشكالاً دينية مختلفة ومتنافسة على معنى الحقيقة حدّ الصراع العنيف بشأنها.
كانت حركة الإصلاح الديني، في القرن السادس عشر، المُعارِضة لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية، وما تلاها من تشكل كنائس بروتستانتية مختلفة ومتنازعة هي الخلفية الدينية التي غذّت هذه الصراعات. ولأن شرعية الحكم السياسي ارتبطت، منذ القرون الوسطى، بالحقيقة الدينية التي تتبناها الدولة، عنى هذا الاختلاف الديني اختلافاً سياسياً في ظل هيمنة الفكرة التقليدية حينها، بأن الهوية الدينية للحاكم ينبغي أن تنعكس على الهوية الدينية للمحكوم، بمعنى أن يكون المحكومون على دين الحاكم. تفككت هذه الفكرة بعد الكثير من الصراع والعنف والدم، ليبرز مكانها تدريجياً مفهوم التسامح الديني الذي قَبل بتعدد المعتقدات الدينية في المجتمع حتى مع اعتبار أحدها، الذي ينتمي إليه الحاكم، هو الأصح، لكن من دون منع المعتقدات الأخرى أو اضطهادها. التسامح أقل من القبول، إذ هو يعني الاضطرار بالقبول بالتنوع من دون الإيمان به فعلاً.
في السياق التاريخي، كانت هذه خطوة جبارة نحو ترسيخ ما كان يُسمى حينه "حرية الضمير"، الاسم الشائع الأقدم لحرية التعبير الذي يعبّر عن فهم تقليدي للأخلاق والضمير بوصف الاثنين نتاجاً للدين كتجربة جمعية، وليسا لتأمل وتطور فرداني للذات في علاقتها بالعالم. بمرور الزمن، ومع الإصلاحات السياسية لشكل الحكم ومحتواه في إطار استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي كانت تجري في المجتمع بعد بروز الثورة الصناعية وامتدادها في القرن التاسع عشر، اتسعت "حرية الضمير" لتشمل أنواعاً أخرى من الحريات في إطار حقوقي يتمحور حول ما أصبح يُعرف تدريجياً باسم الحقوق الطبيعية للفرد، مثل إبداء الآراء المعارضة ونشر الأفكار وإصدار الكتابات وتنظيم الاحتجاجات وتشكيل النقابات والأحزاب. اندرجت هذه كلها في حرية التعبير التي ترسخت أكثر مع بروز مفهوم المساواة بين المواطنين ومن ثم البشر.
عربياً، جاءت "حرية التعبير" في سياق صدمة المواجهة مع أوروبا، في أثناء الحملة الفرنسية لاحتلال مصر في نهاية القرن التاسع عشر التي جلبت معها مفاهيم المساواة وحرية المعتقد.
المساهمة الأهم بهذا الصدد هي تلك التي جاء بها، بعد مغادرة الفرنسيين، حاكم مصر محمد علي باشا ثم خلفاؤه، إذ قام الرجل على امتداد حكمه الطويل المتواصل لأقل من خمسة عقود، بترسيخ المساواة الدينية وضمان حرية العبادة أو المعتقد عبر سلسلة إجراءات إصلاحية، بينها توحيد نظام العقوبات المطبّق على المصريين بغض النظر عن المعتقد الديني، والإدخال المتزايد للأقباط المسيحيين في جهاز الإدارة الحكومي، وإلغاء نظام الجزية المطبّق عليهم، وتشريع الخدمة العسكرية الإلزامية الذي شمل الأقباط أيضاً. عملياً، ألغت هذه الإصلاحات معظم نظام التمييز الديني في مصر منذ الفتح الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي.
لكن، بعيداً من تقويض التمييز الديني وترسيخ حرية الاعتقاد، بقيت إصلاحات محمد علي وخلفائه في جوهرها إدارية وتقنية هدفها الكفاءة وليس الأفكار، إذ ركزت على إعادة تنظيم الدولة وتحسين أدائها، عبر تشكيل جهاز مركزي يديرها بفاعلية ويُحسِّن أداء قطاعاتها المختلفة: الجيش، الزراعة، التعليم، تحصيل الضرائب، تطبيق القانون وسواها. لم ترافقها إصلاحات سياسية تعيد تعريف النظام السياسي الذي بقي سلطانياً ومستبداً. على هذا النحو، لم تمتد "حرية الضمير" لتشمل أنواعاً أخرى من حريات التعبير كما حصل في السياق الأوروبي، حيث حريات الاحتجاج والانتقاد والتنظيم السياسي والحزبي.
وصلت هذه الحريات رسمياً إلى العالم العربي الخاضع للسيطرة العثمانية عند تولي "جمعية الاتحاد والترقي" الحكم في 1908 بعد إنهائها حكم السلطان عبد الحميد الثاني، آخر أعمدة الاستبداد التقليدي في العالم العثماني. أعادت الجمعية العملَ بالدستور العثماني المُشَرّع في عام 1876 وأوقف العمل به السلطان عبد الحميد بعد تشريعه بعامين. أعلنت الجمعية في أشهرها الأولى في الحكم حرية الرعايا العثمانيين في التعبير والمساواة في ما بينهم، بغضّ النظر عن المعتقد الديني، هذا الإعلان الذي كان صادماً في حينه. كما نظمت الدولة انتخابات لاختيار نواب من الولايات للبرلمان العثماني في اسطنبول. لكن مجيء هذه الإصلاحات، بالحريات التي تضمنتها، كان متأخراً بسبب صعود النزعة القومية التركية لدى الجمعية الحاكمة، وإحساس العرب بالتمييز التركي ضدهم، وتفشي الأمية بين الرعايا العثمانيين في الولايات العربية، وأخيراً اندلاع الحرب العالمية الأولى التي تفككت على إثرها الدولة العثمانية.
انتقال الولايات العثمانية العربية إلى السيطرة الأوروبية تحت منظومة الانتداب، وتحوّل معظمها إلى دول باستقلال مشروط بإشراف أوروبي محدود زمنياً، أدخلا بعض الإصلاحات الجدية المتعلقة بحرية التعبير من خلال تشريع قوانين تسمح بالتنظيم السياسي والاحتجاج وحرية الإعلام، في إطار نُظم برلمانية في هذه الدول الناشئة. حتى مع اتساع حيز حرية التعبير النسبي مقارنة بالعهد العثماني، بقيت هذه الإصلاحات، في معظمها، شكلية بسبب الطبيعة الطبقية للأنظمة الحاكمة ونزوعها الاستبدادي، الذي أعاد تكييف القوانين والحياة البرلمانية، لتُفرغ حرية التعبير من محتواها الحقيقي.
حتى المساحة المحدودة نسبياً لحرية التعبير التي كان موجودة في سياق الأنظمة البرلمانية العربية تراجعت كثيراً، بعد وصول الأنظمة القومية العسكرية للحكم، التي قامت بمصادرة الحريات وإنهاء الحياة البرلمانية لمصلحة دكتاتوريات صاعدة ذات طبيعة مركزية في إدارة الحكم والحياة العامة. الجزء اليتيم الذي بقي من حرية التعبير هو "حرية الضمير" بمعناها الديني، أي الحق بممارسة المعتقدات الدينية المختلفة، حتى مع وجود تضييقات سياسية في هذا الجانب، أحياناً كثيرة، بموجب المتطلبات الاستبدادية للحفاظ على الحكم والدفاع عن هويته الأيديولوجية.
في الحقيقة لم يُثَر موضوع حرية التعبير بمعناه الأوسع في معظم العالم العربي إلا بعد اندلاع ما سُمي بثورات "الربيع العربي"، في إطار نزع الشرعية من الأنظمة الدكتاتورية التي كانت ممارساتها القمعية وسياسات تكميم الأفواه بحق الجمهور، أحد أسباب اندلاع هذه الثورات. استطاع "الربيع العربي" أن يطيح أنظمة استبدادية، لكنه فشل في استبدال أخرى ديموقراطية بها.
بسبب هذا الفشل، لا تزال أسئلة حرية التعبير العربية معلقةً من دون أجوبة حاسمة، بعدما اختطفتها الأجواء الانتقالية الطويلة والصعبة التي هيمن عليها الاضطراب السياسي والصراع الأهلي، الناشئان من النجاح في إطاحة القديم، لكن العجز عن المجيء بالجديد.